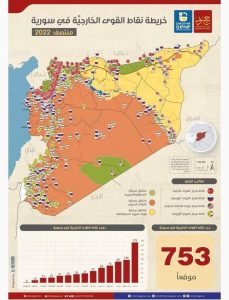No Result
View All Result
المشاهدات 0
آزاد كردي
دخلت الأزمة السورية نفقاً مظلماً لا نهاية له بعد مضي أحد عشر عاماً على بدايتها، دون بصيص أمل للنهاية، عانى السوريون في الأزمة ظروفاً صعبة، دفعوا ثمنها من شقاء عمرهم، وباتت الغالبية منهم تحت خط الفقر، سوريو الداخل يتعرضون لإرهاب اجتماعي سياسي؛ بحثاً عن تسلق هرم السلطة دون أي اعتبارات لهم، فكأنما الحل بالنسبة لهم أشبه بالاستحالة، على الرغم من كونه ممكناً بنموذج الإدارة الذاتية.
الأجندة السياسية السورية الإقليمية كلها، والدولية، مثل؛ جنيف وآستانا وسوتشي، لم تحرز تقدماً يذكر، لا بل العمليات العسكرية كلها، التي نفذها المرتزقة الإرهابيون، أو حكومة دمشق، لم تقدم الحسم النهائي، وتدخلات الدول الإقليمية أو الأطراف الدولية بالصراع الدائر، لوّحت بيديها للدلالة على العجز التام، بينما يبقى مشروع الأمة الديمقراطية ماثلاً بين يدينا من خلال تجربة مناطق شمال وشرق سوريا، ويتجاهله الكثيرون.
وبين كل هذا وذاك، السوريون تعبوا من المصاريف غير المنتهية، وتعبوا من فشلهم من تلبية احتياجاتهم كافة، والتي تكون أحياناً بالدولار، أما الأصعب فقد حُرم الأطفال من الابتسامة البريئة، ولا يُلبى لهم كل ما يريدون، وكذلك أيضاً تفرق شمل الأسر السورية، بعدما صار الغالبية منهم في الشتات، وبلاد الغربة، وعطفاً على ما تقدم، يتساءل السوريون، هل حل الأزمة السورية استحالة، أم ممكن؟

أين أصل المشكلة؟
لابد من القول: إن الأزمة السورية ليست مع (فرد أو مؤسسة مدنية أو عسكرية)، ونتيجة لظروف معينة، أدت إلى تفجير الثورة السورية في عام 2011، أو بما يسمى الربيع السوري آنذاك، وعليه، كيف يمكننا أن نقرأ الإشكالية السياسية السورية في ظل تداخل عشرات التحليلات والتفسيرات؟
ومن هنا، نحاول أن نسوق التفسير والتشخيص للأزمة السورية، وفق ما يلي: فالمعارضة بشقها السياسي، ترى في شخص رئيس حكومة دمشق بشار الأسد، والزمرة الضيقة، التي تحيط به (فرد – مؤسسة)، أصل المشكلة، والتي أحدثت كل ما جرى مع بدء الثورة السورية، وحتى الآن من دمار واسع وأوضاع مأساوية، وهي في الواقع إذ تبني موقفها هذا؛ على عدم قدرة بشار الأسد من القيام بإصلاحات سياسية محدودة، إلى جانب انتشار الفساد والمحسوبية، والتفاوت الطبقي وغلاء الأسعار ومحدودية الأجور، وعلى هذا المنوال ترى المعارضة السورية، أن تنحي شخص رئيس حكومة دمشق، قد يكون حلاً للأزمة السورية المتعثرة.
أما حكومة دمشق؛ المتمثلة بشخص رئيس حكومة دمشق بشار الأسد، ترى أن (ظروفاً معينة/ مؤامرة كونية)؛ الأصل في كل ما حدث من أزمة سورية عميقة، بمراحلها الأولى أو الحالية، وهو يبني موقفه من أن الثورة السورية في الأشهر الأولى، حظيت بتعاطف مجموعة من التيارات المختلفة، والتي كانت تحظى بدعم دول عربية وإقليمية، فضلاً على قوى أخرى دولية، حينها تدفقت الأموال والأسلحة بجنون من كل حدب وصوب، على تنظيمات وألوية، وكتائب لا حصر ولا عد لها، ليظهر بعد ذلك عدد مهول من التنظيمات، التي يصنف بعضها إرهابياً على قوائم الإرهاب الدولي، وهكذا –وبنظر حكومة دمشق-أن المعارضة بشقيها السياسي والعسكري؛ السبب وراء انقسام سوريا، وهو ما سمح بتدخل أطراف أخرى في الصراع.
ولتوضيح ما سبق، يخطئ من يظن، أن سبب الأزمة السورية، كانت مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وما تبعها من أمور كارثية، عانى السوريون منها حتى الآن، وإنما التفسير البنيوي لأصل المشكلة، يعزو لسبب واحد بأن سوريا تفتقد للحياة السياسية الديمقراطية، التي تقوم على مشاركة كل أطياف الشعب بالحراك السياسي، وهذا التفسير يقوم أيضاً وفق أسس، بأن الدولة السورية بشكلها الحالي يحكمها اللون الواحد، واللغة الواحدة، والحزب الواحد، وبمعنى أدق، أن العملية السياسية بعيدة كل البعد عن اصطلاحي (لا تعددية، لا مركزية).
وللتنويه بأن هذين الاصطلاحين السياسيين الأخيرين، لأهميتهما القصوى في الحياة السورية الراهنة، بات يرفعهما حزب سوريا المستقبل، بمناطق شمال وشرق سوريا؛ كمنطلق سياسي له، والحق يقال بأنه الحزب السياسي الوحيد في الجغرافية السورية قاطبة، الذي يملك مشروعاً سياسياً متكاملاً، من شأنه أن يفضي لحل الأزمة السورية الجارية.

انحراف مسار الثورة
لا شك أن الثورة السورية بدأت بمسيرات سلمية، وبمطالب شرعية، لا يختلف حولها أحد، وبعد أن تحول الوضع إلى أن أحداً لم يعد يعرف من يطلق النار على حشود الاحتجاجات؛ ما دفع البعض حينئذ بمطالبات خبيثة بـ “تسليح الثورة”، وأيضاً بتنسيق دول إقليمية مجاورة، ومنظمات دولية، لتصبح سوريا، ولا تزال حتى اليوم، ساحة تصفية حسابات إقليمية ودولية.
ومن الواضح بأن الثورة السورية بعد أحد عشر عاماً، ابتعدت عن مطالبها الأساسية، بالعدل والمساواة، وتداول السلطة، لتحتضنها أنظمة ودول وتكتلات مع مرور الوقت، ومن ثم تشتت المعارضة إلى منصّات خاضعة لمصالح دول مختلفة مثل الدولة التركية، فالمنصات مع مرور الوقت تغيرت، والوجوه تبدلت فيما حكومة دمشق واحدة، وممثلوها لا يتغيّرون ولا يتبدلون، وهذا الأمر كان حجة لها في عجز المعارضة عن الاتفاق” أو بعبارة أدق، الاختلاف، هذا الشطط السياسي أضاع وقتاً طويلاً بين طرفي الأزمة السورية على “محاور أو مسارات محددة”، واجتماعات واتفاقات، إلا أن أياً منها لم يجد الحل بعد.
وفي كل ما يجري من انسداد لآفاق الحل السياسي، بقيت الأزمة الإنسانية تتفاقم بسرعة متزايدة، خاصة مع أزمات معيشية خانقة أبرزها؛ انخفاض الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وأيضاً في ظل تدني للأجور، ناهيك عن فرض عقوبات اقتصادية أثرت بشكل خاص على الفقراء، الذين لا يجدون قوت يومهم، أو بما يعرف بعامل يومية، وتعرض مليونا أسرة سورية، لفقر مدقع حسب ما تورده مفوضية الأمم المتحدة.
أوضاع مأساوية
يعيش السوريون من بعد ثورتهم، أزمة إنسانية خانقة، وأوضاعاً معيشية مأساوية جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، التي لا تنتهي بين الجوع والبرد والحاجة إلى الدواء، وبات معظم السوريين، عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة، وعلى الرغم من وجود أفضلية نسبية بمناطق شمال وشرق سوريا على المناطق الأخرى السورية، من حيث توافر البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية بنسبة أكبر إلا أن القضية الإنسانية أعمق من هذا بكثير، نتيجة تجاهل المجتمع الدولي للحل السياسي، الذي خلّف إجراءات دولية غير موحدة، ومشتتة أرهقت كاهل السوريين، ومنها؛ إغلاق المعابر الإنسانية، وفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وضعف القيمة الشرائية لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، فضلاً عن مخاوف السوريين من النزوح، والترحيل بسبب التهديدات بهجوم عسكري لجيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا؛ ما يعيق أي خطوات ملموسة لقيام الإدارة الذاتية، ببذل المزيد من المشاريع خاصة في الجانب الاجتماعي والخدمي.
كل ذلك كان سبباً في تردي أوضاع السوريين، ما دفع البعض بالهجرة إلى أوروبا، بحثاً عن حياة أفضل بعدما فقدوا أملهم بالوصول إلى حل تام للأزمة السورية المستعصية، وتشهد هذه الفترة قيام عائلات سورية ببيع كل ما تملكه من أجل أن يهاجر أبناؤها من سوريا، في ظل رواج لعصابات المهربين، لتسهيل الهجرة، التي أصبحت تعرض الهجرة إلى تركيا وأوروبا بأسعار خيالية أربعة آلاف دولار لتركيا، و12 ألف دولار لأوروبا!

إمكانية الحل
عشر سنوات منذ بدء الثورة السورية، والعملية السياسية في جمود تام، كما لو أنها تدور في حلقة مفرغة، دون أي تقدم ملموس، وعلى الرغم من عقد مؤتمرات جنيف وسوتشي وآستانا، واتفاقات خفض التصعيد، ومباحثات اللجنة الدستورية إلا أنها كانت في واقع الأمر مضيعة للوقت، فحسب، فيما الحل أبعد من النية الحسنة لوأد الحرب، وإذا كان الحال على ما هو عليه من عقم سياسي يفضي إلى اللانهاية، فما هو الحل؟ يبدو الحديث عن أي عملية سياسية لا تتناول ملف التسوية السياسية، وملف الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، حديث يفاقم الأزمة السورية ولا يعالجها، لا سيما أن المعارضة وحكومة دمشق يحاولان دس السم في العسل وسط محاولة تحقيق أحدهما إنجازات على الأرض على حساب الآخر.
أما الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الطرف الوحيد، التي تقدم رؤيتها للحل السوري، التي تتطابق مع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو لجهود لدعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ويدعو لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة تجرى عملًا بالدستور الجديد، فـي غضون 18 شهراً تحـت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يكون مشروطاً بمشاركة الإدارة الذاتية في هذه العملية على اعتبار بأن هذه المناطق ذات طيف واسع من الشعب السوري المتنوع، الذي حرم لعقود من المشاركة السياسية الحقيقية، إلى جانب ملفات أخرى؛ كملفي المفقودين، والمعتقلين السياسيين.
حل واحد لا ثاني له
افتقدت سوريا منذ عقود طويلة الحراك السياسي القائم على تبادل السلطة بشكل ديمقراطي حر دون إقصاء لأحد، ولما قامت الثورة السورية، تنفس السوريون آنذاك، أنفاس الحرية ومذاق التعبير عن الرأي، وكانوا يأملون أن يعيشوا بحرية وعزة وكرامة، شأنه في ذلك، شأن بقية شعوب العالم، وأيضاً أن تتمكن القوى الوطنية من الالتفاف حول كلمة سواء، يجتمع حولها السوريون، وهي ما من شك، مشروع الأمة الديمقراطية.
يعد المشروع المطروح في شمال وشرق سوريا؛ المتمثل بالإدارة الذاتية الخلاص للسوريين؛ لأنه يمتلك كافة المقومات التي توفر للشعب؛ العيش بسلام وأمان بمناطق شمال وشرق سوريا بشكل خاص، ولأبناء سوريا بشكل عام، وخلال السنوات الماضية أثبتت التجربة العملية لمشروع الإدارة الذاتية على أرض الواقع أنه الأفضل، والناجح والأمثل لما تمر به سوريا من أزمات وفق الأسس التالية:
-الحل السوري لن يمر دون وجود منطقة الإدارة الذاتية، التي تملك قرابة خمس مليون نسمة؛ ما يجعلها توازي المناطق الأخرى بالعدد والتنوع السكاني من قوميات مختلفة، ولن يكون النمط السياسي القديم السلطوي بكل سلبياته الشمولية، قادراً على تلبية رغباتها بالتحول الديمقراطي المنشود.
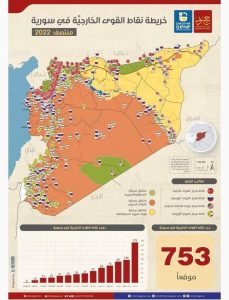
-يعدّ مشروع الأمة الديمقراطية ممكناً إذا علمنا بأن مقوماته، وأسسه السياسية والاجتماعية والتاريخية، والأنثروبولوجية، نابعة من صميم البيئة السورية، التي كانت على الدوام مثار إشكاليات، ونعرات طائفية ومذهبية، وعرقية لعدم التوافق بين البنى الاجتماعية، والأدلجة السياسية المختلفة؛ نظراً لأن القالب الشكلي للدولة السورية قائم وفق النظام القومي، ولذا ليس بوسع أي مشروع آخر إيجاد التوافقات، والروابط المتينة للمشاكل والحلول، كالذي يقدمها مشروع الأمة الديمقراطية المنسجم مع كل قضايا الدين والعشائرية والمرأة والمجتمع أيضاً.
-التهديدات المحيطة بكل سوريا، وخاصة من قبل جيش الاحتلال التركي، وانتشار النعرات الطائفية في بعض المناطق، وتهديد مرتزقة داعش من الداخل، ينبغي على السوريين أن يعلموها، والذين هم أحوج ما يكونون للأمن والاستقرار، ولن يكون ذلك إلا بمشروع الأمة الديمقراطية.
No Result
View All Result